إثبات كون القرآن كلام اللّه ومعجزاً ودفع شبهات القسيسين و إثبات صحة الأحاديث النبوية المروية في كتب الصحاح من كتب: أهل السنة والجماعة.
الفصل الأول: في اثبات أن القرآن كلام اللّه
الأمور التي تدل على أن القرآن كلام اللّه كثيرة، أكتفي منها على اثني عشر أمراً على عدد حواري المسيح وأترك الباقي، مثل أن يقال إن الخائب المخالف وقت بيان أمر من الأمور الدنيوية والدينية أيضاً يكون ملحوظاً في القرآن، وأن بيان كل شيء
ترغيباً كان أو ترهيباً رأفة كان أو عتاباً يكون على درجة الاعتدال لا بالإفراط ولا بالتفريط، وهذان الأمران لا يوجدان في كلام الإنسان لأنه يتكلم في بيان كل حال بما يناسب ذلك الحال، فلا يلاحظ في العتاب حال الذين هم قابلون للرأفة وبالعكس، ولا يلاحظ عند ذكر الدنيا حال الآخرة وبالعكس. ويقول في الغضب زائداً على الخطأ وهكذا أمور أخر.(الأمر الأول): كونه في الدرجة العالية من البلاغة التي لم يعهد مثلها في تراكيبهم وتقاصرت عنها درجات بلاغتهم، وهي عبارة عن التعبير باللفظ المعجب عن المعنى المناسب للمقام الذي أورد فيه الكلام، بلا زيادة ولا نقصان في البيان، والدلالة عليه، وعلى هذا كلما ازداد شرف الألفاظ ورونق المعاني ومطابقة الدلالة كان الكلام أبلغ وتدل على كونه في هذه الدرجة وجوه:
(أولها) أن فصاحة العرب أكثرها في وصف المشاهدات مثل وصف بعير أو فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب أو وصف غارة. وكذا فصاحة العجم سواء كانوا شاعرين أو كاتبين أكثرها في أمثال هذه الأشياء. ودائرة الفصاحة والبلاغة فيها متسعة جداً لأن طبائع أكثر الناس تكون مائلة إليها. وظهر من الزمان القديم في كل وقت وفي كل إقليم من شاعر أو كاتب مضمون جديد ونكتة لطيفة في بيان لشيء من هذه الأشياء المذكورة ويكون المتأخر المتتبع واقفاُ على تدقيقات المتقدم غالباً. فلو كان الرجل سليم الذهن وتوجه إلى تحصيل ملكة في وصفها يحصل له بعد الممارسة والاشتغال ملكة البيان في وصف شيء من هذه الأشياء على قدر سلامة فكره وجودة ذهنه، وليس القرآن في بيان خصوص هذه الأشياء فكان يجب أن لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتفقت عليها العرب في كلامهم.
(ثانيها) أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق وتنزه عن الكذب في جميعه، وكل شاعر ترك الكذب والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن جيداً، ولذلك قيل أحسن الشعر أكذبه. وترى أن لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت رضي اللّه عنهما لما أسلما نزل شعرهما ولم يكن شعرهما الإسلامي كشعرهما الجاهلي، والقرآن جاء فصيحاً مع التنزه عن الكذب والمجازفة.
(ثالثها) أن الكلام الفصيح إنما يتفق في القصيدة في البيت والبيتين والباقي لا يكون كذلك، بخلاف القرآن فإنه مع طوله فصيح كله، بحيث يعجز الخلق عنه. ومن تأمل في قصة يوسف عليه السلام عرف أنها مع طولها وقعت على الدرجة العالية من البلاغة.
(رابعها) أن الشاعر أو الكاتب إذا كرر مضموناً أو قصة لا يكون كلامه الثاني مثل الأول، وقد تكررت قصص الأنبياء وأحوال المبدأ والمعاد والأحكام والصفات الإلهية، واختلفت العبارات إيجازاً وإطناباً وتفنناً في بيانها غيبة وخطاباً، ومع ذلك كل واحد منها في نهاية الفصاحة ولم يظهر التفاوت أصلاً.
(خامسها) أنه اقتصر على إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على مكارم الأخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة، وأمثال هذه الأمور توجب تقليل الفصاحة. ولذلك إذا قيل لشاعر فصيح أو كاتب بليغ أن يكتب تسع أو عشر من مسائل الفقه أو العقائد في عبارة فصيحة مشتملة على التشبيهات البليغة والاستعارات الدقيقة يعجز.
(سادسها) أن كل شاعر يحسن كلامه في فن فإنه يضعف كلامه في غير ذلك الفن، كما قالوا في شعراء العرب: إن شعر امرئ القيس يحسن عند الطرب وذكر النساء وصفة الخيل، وشعر النابغة عند الخوف وشعر الأعشى عند الطلب ووصف الخمر وشعر زهير عند الرغبة والرجاء. وقالوا في شعراء فارس إن النظامي والفردوسي وحيدان في بيان الحرب، والسعدي فريد في الغزل، والأنوري في القصائد.. والقرآن جاء فصيحاً على غاية الفصاحة في كل فن ترغيباً كان أو ترهيباً، زجراً كان أو وعظاً أو غيرهما. (وأورد ههنا بطريق الأنموذج من كل فن آية آية) ففي الترغيب قوله {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين} وفي الترهيب قوله {وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ} وفي الزجر والتوبيخ قوله {فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً. ومنهم من أخذته الصيحة. ومنهم من خسفنا به الأرض. ومنهم من أغرقنا. وما كان اللّه ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} وفي الوعظ قوله {أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغني عنهم ما كانوا يمتعون} وفي الإلهيات قوله {اللّه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال}.
(سابعها) الأغلب أنه إذا انتقل الكلام من مضمون إلى مضمون آخر، واشتمل على بيان أشياء مختلفة لا يبقى حسن ربط الكلام ويسقط عن الدرجة العالية للبلاغة. والقرآن يوجد فيه الانتقال من قصة إلى قصة إلى قصة أخرى، والخروج من باب إلى باب، والاشتمال على أمر ونهي، وخبر واستخبار، ووعد وعيد، وإثبات النبوة، وتوحيد الذات، وتفريد الصفات، وترغيب وترهيب، وضرب مثال، وبيان حال. ومع ذلك يوجد فيه كمال الربط والدرجة العالية للبلاغة الخارجة عن العادة فتحير فيها عقول بلغاء العرب.
(ثامنها) أن القرآن في أغلب المواضع يأتي بلفظ يسير متضمن لمعنى كثير ويكون اللفظ أعذب، ومن تأمل في سورة (ص) علم ما قلت كيف صدرها وجمع فيها من أخبار الكفار وخلافهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم ومن تكذيبهم لمحمد صلى اللّه عليه وسلم، وتعجبهم مما أتى به، والخبر عن إجماع ملئهم على الكفر، وظهور الحسد في كلامهم، وتعجيزهم وتحقيرهم ووعيدهم بخزي الدنيا والآخرة، وتكذيب الأمم قبلهم وإهلاك اللّه لهم، ووعيد قريش وأمثالهم مثل مصابهم. وحمل النبي على الصبر على أذاهم وتسليته في قصص الأنبياء مثل داود وسليمان وأيوب وإبراهيم ويعقوب وغيرهم عليهم السلام. وكل هذا الذي ذكر من أولها إلى آخرها في ألفاظ يسيرة متضمنة لمعان كثيرة، وكذلك قوله تعالى {ولكم في القصاص حياة} فإن هذا القول لفظه يسير ومعناه كثير. ومع كونه بليغاً مشتملاً على المطابقة بين المعنيين المتقابلين وهما القصاص والحياة. وعلى الغرابة، بجعل القتل الذي هو مفوت للحياة ظرفاً لها وأولى من جميع الأقوال المشهورة عند العرب في هذا الباب، لأنهم عبروا عن هذا المعنى بقولهم: (قتل البعض إحياء الجميع) وقولهم: (أكثروا القتل ليقل القتل) وقولهم: (القتل أنفى للقتل). وأجود الأقوال المنقولة عن القول الأخير ولفظ القرآن أفصح منه بستة أوجه: (أحدها): أنه أخصر من الكل لأن قوله {ولكم} لا يدخل في هذا الباب لأنه لا بد من تقدير ذلك في الكل لأن قول القائل قتل البعض إحياء للجميع لا بد فيه من تقدير مثله وكذلك في قولهم القتل أنفى للقتل. (وثانيها): أن قولهم القتل أنفى للقتل ظاهرة يقتضي كون الشيء سبباً لانتفاء نفسه بخلاف لفظ القرآن فإنه يقتضي أن نوعاً من القتل وهو القصاص سبب لنوع من أنواع الحياة. (وثالثها): أن قولهم الأجود تكرير لفظ القتل بخلاف لفظ القرآن. (ورابعها): أن قولهم الأجود لا يفيد إلا الردع عن القتل، بخلاف لفظ القرآن فإنه يفيد الردع عن القتل والجرح فهو أفيد.
(وخامسها): أن قولهم الأجود دال على ما هو المطلوب بالتبع بخلاف لفظ القرآن فإنه دال على ما هو مقصود أصلي، لأن نفي القتل مطلوب تبعاً من حيث إنه يتضمن حصول الحياة الذي هو مطلوب أصالة. (وسادسها): أن القتل ظلماً أيضاً قتل مع أنه ليس بناف للقتل بخلاف القصاص فظاهر قولهم باطل وأما لفظ القرآن فصحيح ظاهراً وباطناً. وكذلك قوله تعالى: {مع يطع اللّه} في فرائضه {ورسوله} في سننه أو في جميع ما يأمرانه وينهيانه {ويخشى اللّه} أي يخف خلافه وعقابه وحسابه {ويتقه} فيما بقي من عمره في جميع أمره {فأولئك هم الفائزون} بالمراد في المبدأ والمعاد، فإن هذا القول مع وجازة لفظه جامع لجميع الضروريات (حكي) أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه كان يوماً نائماً في المسجد فإذا هو بقائم على رأسه يتشهد شهادة الحق فأعلمه أنه من بطارقة الروم ومن جملة من يحسن فهم الألسن من العرب وغيرها، وأنه سمع رجلاً من أسراء المسلمين يقرأ آية من كتابكم فتأملها فإذا هي جامعة لكل ما أنزل اللّه على عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والآخرة، وهي قوله {ومن يطع اللّه ورسوله} الآية. وحكي أن طبيباً نصرانياً حاذقاً سأل الحسين بن علي الواقدي: لماذا لم ينقل شيء في كتابكم عن علم الطب.. والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان. فقال الحسين: إن اللّه بين علم الطب كله في نصف آية، فسأل الطبيب النصراني عن هذه الآية. فقال: هي قوله: {كلوا واشربوا} ما أحل اللّه لكم من المطعومات والمشروبات {ولا تسرفوا} أي لا تتعدوا إلى الحرام ولا تكثروا الإنفاق المستقبح، ولا تناولوا مقداراً كثيراً يضركم ولا تحتاجون إليه. ثم سأل الطبيب أقال نبيكم أيضاً شيئاً في هذا الأمر، فقال الحسين: إن نبينا أيضاً جمع الطب في ألفاظ يسيرة، فسأل الطبيب عنها، فقال الحسين: هي هذه: "المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته" فقال الطبيب: الإنصاف أن كتابكم ونبيكم ما تركا حاجة إلى جالينوس، يعني بينا الأمر الذي هو رأس حفظ الصحة وإزالة المرض وأصلهما ومضارهما.
(تاسعها): أن الجزالة والعذوبة بمنزلة الصفتين المتضادتين، واجتماعهما على ما هو ينبغي في كل جزء من الكلام الطويل خلاف العادة المعتادة للبلغاء، فاجتماعهما في كل موضع من مواضع القرآن كله دليل على كمال بلاغته وفصاحته الخارجتين عن العادة.
(عاشرها): أنه مشتمل على جميع فنون البلاغة من ضروب التأكيد وأنواع التشبيه والتمثيل، وأصناف الاستعارة وحسن المطالع والمقاطع، وحسن الفواصل، والتقديم والتأخير والفصل والوصل اللائق بالمقام، وخلوه عن اللفظ الركيك والشاذ الخارج عن القياس النافر عن الاستعمال، وغير ذلك من أنواع البلاغات. ولا يقدر أحد من البلغاء والكملاء من العرب العرباء إلا على نوع أو نوعين من الأنواع المذكورة، ولو رام غيره في كلامه لم يتأت له، وكان مقصراً. والقرآن محتو عليها كلها فتلك عشرة كاملة، وهذه الوجوه العشرة تدل على أن القرآن في الدرجة العالية من البلاغة الخارجة عن العادة، يعرفه فصحاء العرب بسليقتهم، وعلماء الفرق بمهارتهم في فن البيان وإحاطتهم بأساليب الكلام، ومن كان أعرف بلغة العرب وفنون بلاغتها كان أعرف بإعجاز القرآن.
(الأمر الثاني): تأليفه العجيب وأسلوبه الغريب في المطالع والمقاطع والفواصل، مع اشتماله على دقائق البيان وحقائق العرفان، وحسن العبارة، ولطف الإشارة، وسلامة التركيب، وسلامة الترتيب، فتحيرت فيه عقول العرب العرباء، وفهوم الفصحاء. والحكمة في هذه المخالفة أن لا يبقى لمتعسف عنيد مظنة السرقة، ويمتاز هذا الكلام عن كلامهم ويظهر تفوقه، لأن البليغ ناظماً كان أو ناثراً يجتهد في هذه المواضع اجتهاداً كاملاً، ويمدح ويعاب عليه غالباً في هذه المواضع كما عيب على مطلع امرئ القيس:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل .. بسقط اللوى بين الدخول فحومل
بأن صدر البيت جمع بين عذوبة اللفظ وسهولة السبك وكثرة المعاني فإنه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل، وأن الشطر الثاني لا يوجد فيه شيء من ذلك... وعيب على مطلع أبي النجم الشاعر المشهور فإنه دخل على هشام بن عبد الملك، فأنشده:
صفراء قد كادت ولما تفعل .. كأنها في الأفق عين الأحوال
وكان هشام أحول فأخرجه وأمر بحبسه.
وعيب على مطلع جرير، فإنه دخل على عبد الملك وقد مدحه بقصيدة حائية. أولها:
أتصحو أم فؤداك غير صاح
فقال له عبد الملك: بل فؤادك يا ابن الفاعلة .
.
وعيب على مطلع البحتري فإنه أنشد يوسف بن محمد قصيدته التي مطلعها:
لك الويل من ليل تقاصر آخره
فقال: بل لك الويل والخزي... وعيب على مطلع إسحاق الموصلي الأديب الحاذق، فإنه دخل على المعتصم وقد فرغ من بناء قصره بالميدان وأنشده قصيدته التي مطلعها:
يا دار غيرك البلى ومحاك * يا ليت شعري ما الذي أبلاك!!
فتطير المعتصم من هذا المطلع وأمر بهدم القصر على الفور. وهكذا قد خطئ أكثر الشعراء المشهورين في المواضع المذكورة. وأشراف العرب، مع كمال حذاقتهم في أسرار الكلام وشدة عداوتهم للإسلام، لم يجدوا في بلاغة القرآن وحسن نظمه وأسلوبه مجالاً لم يوردوا في القدح مقالاً، بل اعترفوا أنه ليس من جنس خطب الخطباء وشعر الشعراء، ونسبوه تارةً إلى السحر تعجباً من فصاحته وحسن نظمه، وقالوا تارةً إنه إفك افتراه وأساطير الأولين، وقالوا تارةً لأصحابهم وأحبابهم لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه لعلكم تغلبون. وهذه كلها دأب المحجوج المبهوت. فثبت أن القرآن معجز ببلاغته وفصاحته وحسن نظمه. وكيف يتصور أن يكون الفصحاء والبلغاء من العرب العرباء كثيرين كثرة رمال الدهناء وحصى البطحاء، ومشهورين بغاية العصبية والحمية الجاهلية، وتهالكهم على المباراة والمباهاة، والدفاع عن الأحساب. فيتركون الأمر الأسهل الذي هو الإيتان بمقدار أقصر سورة ويختارون الأشد الأصعب مثل الجلاء وبذل المهج والأرواح، ويبتلون بسبي الذراري ونهب الأموال، ومخالفهم المتحدي يقرعهم إلى مدة على رؤوس الملأ بأمثال هذه الأقوال: {فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون اللّه إن كنتم صادقين}. {وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اللّه إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة}. {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً}. ولو كانوا يظنون أن محمداً صلى اللّه عليه وسلم استعان بغيره، لأمكنهم أيضاً أن يستعينوا بغيرهم لأنه كأولئك المنكرين في معرفة اللغة وفي المكنة من الاستعانة، فلما لم يفعلوا ذلك وآثروا المقارعة على المعارضة والمقاتلة على المقاولة، ثبت أن بلاغة القرآن كانت مسلمة عندهم وكانوا عاجزين عن المعارضة، غاية الأمر أنهم صاروا مفترقين بين مصدق به وبمن أنزل عليه، وبين متحير في بديع بلاغته. روي أنه سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى اللّه عليه وسلم {إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون} فقال: واللّه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر ما يقول هذا بشر.. وروي أيضاً أنه لما سمع القرآن رق قلبه، فجاءه أبو جهل وكان ابن أخيه منكراً عليه قال: واللّه ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني، واللّه ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا. وروي أيضاً أنه جمع قريشاً عند حضور الموسم وقال: إن وفود العرب ترد العرب فاجمعوا فيه رأياً لا يكذب بعضكم بعضاً، قالوا: نقول كاهن، قال: واللّه ما هو بكاهن بزمزمته ولا سجعته. قالوا: مجنون، قال: ما هو بمجنون ولا بحنقه ولا وسوسته، قالوا: فنقول شاعر، قال: ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه، وقريضه ومبسوطه ومقبوضه. قالوا: فنقول ساحر، قال: ما هو بساحر ولا نفثه ولا عقده، قالوا: فما نقول. قال: ما أنتم بقائلين شيئاً من هذا إلا وأنا أعرف أنه باطل وأن أقرب القول إنه ساحر. ثم قال: فإنه سحر يفرق به بين المرء وابنه، والمرء وأخيه، والمرء وزوجه، والمرء وعشيرته، فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس عن متابعة النبي صلى اللّه عليه وسلم، فأنزل اللّه تعالى في الوليد: {ذروني ومن خلقت وحيداً}..الآيات. وروي أن عتبة كلم النبي صلى اللّه عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه، فتلا عليه: {حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت..} إلى قوله: {أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود}. فأمسك عتبة بيده على فيه وناشده الرحم أن يكف، وفي رواية فجعل النبي صلى اللّه عليه وسلم يقرأ وعتبة مصغ ملق بيديه خلف ظهره معتمد عليهما حتى انتهى إلى السجدة فسجد النبي صلى اللّه عليه وسلم، وقام عتبة لا يدري بما يراجعه، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه، فاعتذر لهم وقال واللّه لقد كلمني بكلام ما سمعت أذناي بمثله قط فما دريت ما أقول له... وذكر أبو عبيدة أن أعرابياً سمع رجلاً يقرأ {فاصدع بما تؤمر} فسجد وقال سجدت لفصاحته، وسمع رجل آخر من المشركين رجلاً من المسلمين يقرأ: {فما استيأسوا منه خلصوا نجياً} فقال: أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام.. وحكى الأصمعي أنه سمع جارية تتكلم بعبارة فصيحة وإشارة بليغة وهي خماسية أو سداسية، وهي تقول أستغفر اللّه من ذنوبي كلها، فقال: مم تستغفرين ولم يجر عليك قلم؟ فقالت:
أستغفر اللّه لذنبي كله * قتلت إنساناً بغير حله
مثل غزال ناعم في دله * انتصف الليل ولم أصله
فقال لها: قاتلك اللّه ما أفصحك، فقالت: أو بعد هذا فصاحة بعد قوله تعالى: {وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين} فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين.. وفي حديث إسلام أبي ذر ووصف أخاه أنيساً فقال: واللّه ما سمعت بأشعر من أخي أنيس لقد ناقض اثني عشر شاعراً في الجاهلية أنا أحدهم، وأنه انطلق إلى مكة وجاءني، قلت: فما يقول الناس، قال: يقولون شاعر كاهن ساحر ثم قال: لقد سمعت ما قال الكهنة فما هو قولهم ولقد وضعته على إقراء الشعر فلم يلتئم وما يلتئم على لسان أحد بعدي إنه شعر وإنه لصادق وإنهم لكاذبون. وروي في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي اللّه عنه قال: سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: {أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون}. كاد قلبي أن يطير للإسلام. وقد حكي أن ابن المقفع طلب معارضة القرآن وشرع فيه فمر بصبي يقرأ: {وقيل يا أرض ابلعي ماءك} فرجع فمحا ما عمل وقال: أشهد أن هذا لا يعارض وما هو من كلام البشر. وكان يحيى بن حكم الغزالي بليغ الأندلس في زمنه فحكى أنه رام شيئاً من هذا فنظر في سورة الإخلاص ليأتي على أسلوبها وينظم الكلام على منوالها، قال: فاعترتني منه خشية ورقة حملتني على التوبة والإنابة. وقال النظام من المعتزلة: إعجاز القرآن بالصرف، على معنى أن العرب كانت قادرة على كلام مثل القرآن قبل مبعث النبي صلى اللّه عليه وسلم، لكن اللّه صرفهم عن معارضته بسبب الدواعي بعد المبعث فهذا الصرف خارق للعادة فيكون معجزاً، فهو أيضاً يسلم أن القرآن معجز لأجل الصرف ومثله غير مقدور لهم بعد المبعث، وإنما نزاعه في كونه مقدور قبل المبعث وقوله غير صحيح بوجوه: (الأول): أنه لو كان كذا لعارضوا القرآن بالكلام الذي صدر عنهم قبل المبعث ويكون مثل القرآن. (والثاني): أن فصحاء العرب إنما كانوا يتعجبون من حسن نظمه وبلاغته وسلالته في جزالته، لا لعدم تأتي المعارضة مع سهولتها في نفسها. (والثالث): أنه لو قصد الإعجاز بالصرف لكان الأنسب ترك الاعتناء ببلاغته وعلو طبقته، لأن القرآن على هذا التقدير كلما كان أنزل في البلاغة، وأدخل في الركاكة، كان عدم تيسر المعارضة أبلغ في خرق العادة. (والرابع): يأباه قوله تعالى: {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا}..
فإن قيل: إن فصحاء العرب لما كانوا قادرين على التكلم بمثل مفردات السورة ومركباتها القصيرة، كانوا قادرين على الإتيان بمثلها (قلت) هذه الملازمة ممنوعة لأن حكم الجملة قد يخالف حكم الأجزاء، ألا ترى أن كل شعرة شعرة لا يصلح أن يربط بها الفيل أو السفينة، وإذا سوى من الشعرات حبل متين يصلح أن يربط بهذا الحبل الفيل أو السفينة، ولأنها لو صحت لزم أن يكون كل آحاد العرب قادر على الإتيان بمثل قصائد فصحائهم كامرئ القيس وأضرابه.
(الأمر الثالث): كون القرآن منطوياً على الإخبار عن الحوادث الآتية، فوجدت في الأيام اللاحقة على الوجه الذي أخبر.
1- كقوله تعالى: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء اللّه آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون}.فوقع كما أخبر، ودخل الصحابة المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين غير خائفين. 2- وكقوله تعالى: {وعد اللّه الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً}. فكان اللّه وعد المؤمنين بجعل الخلفاء منهم وتمكين الدين المرضي لهم، وتبديل خوفهم بالأمن، فوفى وعده في مدة قليلة بأن ظهر في حياة الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن أهل الإسلام تسلطوا على مكة، وخيبر والبحرين، ومملكة اليمن، وأكثر ديار العرب، وأن إقليم الحبش صار دار الإسلام بإيمان النجاشي الملك، وأن أناساً من هجر وبعض المسيحيين من نواحي الشام قبلوا الإطاعة وأداء الجزية، وأن هذا التسلط زاد في خلافة الصديق الأكبر رضي اللّه عنه بأن تسلط أهل الإسلام على بعض ديار فارس وعلى بصرى ودمشق، وبعض الديار الأخرى من الشام أيضاً، ثم زاد هذا التسلط في خلافة الفاروق رضي اللّه عنه بأن تسلطوا على سائر ديار الشام وجميع مملكة مصر، وعلى أكثر ديار فارس أيضاً، ثم زاد هذا التسلط في خلافة ذي النورين رضي اللّه عنه، بأن تسلطوا في جانب الغرب إلى أقصى الأندلس والقيروان، وفي جانب الشرق إلى حد الصين، ففي مدة ثلاثين سنة تسلط أهل الإسلام على هذه الممالك تسلطاً تاماً، وغلب دين اللّه المرضي على سائر الأديان في هذه المماليك فكانوا يعبدون اللّه آمنين غير خائفين. وفي خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه وإن لم يتسلط أهل الإسلام على الممالك الجديدة لكنه لا شبهة في ترقي الملة الإسلامية في عهده الشريف أيضاً. 4- وكقوله تعالى: {ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون}. ووقع كما أخبر لأن المراد بقوم أولي بأس على أظهر الوجوه وأشهرها، بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب والداعي الصديق الأكبر رضي اللّه عنه. 5- وكقوله تعالى: {هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله}. وحال هذا القول كحال القول الثاني وسيظهر الوفاء الكامل لهذا الوعد عن قريب على ما هو المرجو إن شاء اللّه. وهو على كل شيء قدير.5- وكقوله تعالى: {لقد رضي اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان اللّه عزيزاً حكيماً. وعدكم اللّه مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط اللّه بها وكان اللّه على كل شيء قديراً}. والمراد بالفتح القريب فتح خيبر، وبالمغانم الكثيرة في الموضع الأول مغانم خيبر أو هجر وبالمغانم الكثيرة في الموضع الثاني المغانم التي تحصل للمسلمين من يوم الوعد إلى يوم القيامة، وبأخرى مغانم هوازن أو فارس أو الروم وقد وقع كما أخبر. 6- وكقوله تعالى: {وأخرى تحبونها نصر من اللّه وفتح قريب}. فقوله أخرى أي يعطيكم خصلة أخرى، وقوله نصر من اللّه مفسر للأخرى وقوله فتح قريب، أي عاجل وهو فتح مكة. وقال الحسن: هو فتح فارس والروم وقد وقع كما أخبر. 7- وكقوله تعالى: {إذا جاء نصر اللّه والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللّه أفواجاً}. والمراد بالفتح فتح مكة، لأن الأصح أن هذه السورة نزلت قبل فتح مكة لأن {إذا} يقتضي الاستقبال ولا يقال فيما وقع إذا جاء وإذا وقع، فحصل فتح مكة ودخل الناس في الإسلام فوجاً بعد فوج من أهل مكة والطائف وغيرها في حياته صلى اللّه عليه وسلم. 8- وكقوله تعالى: {قل للذين كفروا ستغلبون}. وقد وقع كما أخبر فصاروا مغلوبين. 9- وكقوله تعالى: {وإذ يعدكم} أي اذكروا إذ يعدكم {اللّه إحدى الطائفتين} القافلة الراجعة من الشام والقافلة الآتية من بيت اللّه الحرام {أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة} أي القافلة الراجعة {تكون لكم ويريد اللّه أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين} فوقع كما أخبر.
10- وكقوله تعالى: {إنا كفيناك المستهزئين}. لما نزلت هذه الآية بشر النبي صلى اللّه عليه وسلم أصحابه بأن اللّه كفاه شرهم وأذاهم وكان المستهزئون نفراً بمكة ينفرون الناس عنه ويؤذونه فهلكوا بضروب البلاء وفنون العناء فتم نوره وكمل ظهوره. 11- وكقوله تعالى: {واللّه يعصمك من الناس}. وقد وقع كما أخبر مع كثرة من قصد ضره فعصمه اللّه تعالى، حتى انتقل من الدار الدنيا إلى منازل الحسنى في العقبى. 12- وكقوله تعالى: {الم غلبت الروم في أدنى الأرض} أي أرض العرب {وهم} أي الروم {من بعد غلبهم سيغلبون} أي الفرس {في بضع سنين} أي ما بين الثلاث والعشر {ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللّه ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد اللّه لا يخلف اللّه وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون}. الفرس كانوا مجوساً والروم نصارى، فورد خبر غلبة الفرس إياهم مكة ففرح المشركون وقالوا أنتم والنصارى أهل الكتاب ونحن وفارس أميون لا كتاب لنا، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم، ولنظهرن عليكم. فنزلت هذه الآيات. فقال أبو بكر رضي اللّه عنه: لا يقرن اللّه أعينكم فو اللّه لتظهرن الروم على فارس في بضع سنين فقال أُبَيّ بن خلف: كذبت اجعل بيننا وبينك أجلاً فراهنه على عشر قلائص من كل واحد منهما وجعلا الأجل ثلاث سنين فأخبر أبو بكر رضي اللّه عنه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال: البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايده في الإبل وماده في الأجل، فجعلها مائة قلوص إلى تسع سنين، ومات أبي بعد ما رجع من أحد وظهرت الروم على فارس في السنة السابعة من مغلوبيتهم فأخذ أبو بكر القلائص من ورثة أبي، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: تصدق بها.
قال صاحب ميزان الحق في الفصل الرابع من الباب الثالث: (لو فرضنا صدق ادعاء المفسرين أن هذه الآية نزلت قبل غلبة الروم الفرس فنقول إن محمداً صلى اللّه عليه وسلم قال بظنه أو بصائب فكره لتسكين قلوب أصحابه، وقد سمع مثل هذه الأقوال من أصحاب العقل والرأي في كل زمان) انتهى. فقوله لو فرضنا صدق ادعاء المفسرين، يشير إلى أن هذا الأمر ليس بمسلم عنده، وهذا عجيب لأن قوله تعالى {سيغلبون في بضع سنين}، نص في أن هذا الأمر يحصل في الزمان المستقبل القريب في زمان أقل من عشر سنين كما هو مقتضى لفظ السنين والبضع، وكذا قوله {ويومئذ يفرح المؤمنون}، وقوله {وعد اللّه لا يخلف اللّه وعده}، لأنهما يدلان على حصول فرح في الزمان الآتي وحصول هذا الأمر فيه، ولا معنى للوعد وعدم الخلف في الأمر بعد وقوعه وقوله إن محمداً صلى اللّه عليه وسلم قال بظنه أو بصائب فكره مردود بوجهين: (الأول): أن محمداً صلى اللّه عليه وسلم كان من العقلاء عند المسيحيين أيضاً ويعترف بهذا القسيس النبيل ههنا وفي المواضع الأخر من تصانيفه، وليس من شأن العاقل المدعي للنبوة أن يدعي ادعاء قطعياً أن الأمر الفلاني يكون في المدة القليلة هكذا ألبتة ويأمر معتقديه بالرهان على هذا، سيما في مقابلة المنكرين الطالبين لمذلته، المتفحصين لمزلة أقدامه في أمر لا يكون وقوعه مفيداً فائدة يعتد بها، ويكون عدم وقوعه سبباً لمذلته وكذبه عندهم، ويحصل لهم سند عظيم لتكذيبه. (والثاني): أن العقلاء وإن كانوا يقولون في بعض الأمور بعقولهم ويكون ظنهم صحيحاً تارةً وخطأ أخرى لكن جرت العادة الإلهية بأن القائل لو كان مدعي النبوة كذباً ويخبر عن الحادثة الآتية، ويفتري على اللّه بنسبة هذا الخبر إلى اللّه، لا يكون هذا الخبر صحيحاً بل يخرج خطأ وغلطاً ألبتة كما ستعرف في آخر هذا المبحث إن شاء اللّه. 13- وكقوله تعالى: {أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر}. عن عمر رضي اللّه تعالى عنه أنه قال لما نزلت: لم أعلم ما هو حتى كان يوم بدر سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو يلبس درعه ويقول: {سيهزم الجمع}. فعلمته.
14- وكقوله تعالى: {قاتلوهم يعذبهم اللّه بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين}. وقد وقعت هذه الأحوال كما أخبر. 15- وكقوله تعالى: {لن يضروكم إلا أذى} إما بالطعن في محمد وعيسى عليهما السلام، وإما بتخويف الضعفة من المسلمين {وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون} فأخبر فيه عن ثلاث مغيبات: (الأول): أن المؤمنين يكونون آمنين من ضرر اليهود. (والثاني): لو قاتلوا المؤمنين ينهزمون. (والثالث): أنه لا يحصل لهم قوة وشوكة بعد الانهزام وكلها وقع. 16- وكقوله تعالى: {ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من اللّه وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللّه وضربت عليهم المسكنة}. وقد وقع كما أخبر وليس لليهود حكومة في موضع من المواضع وفي كل إقليم يوجدون رعايا مضروباً عليهم الذلة 17- وكقوله تعالى: {سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب} وقد وقع يوم أحد بوجهين كما أخبر.(الأول): أن المشركين لما استولوا يوم أحد على المسلمين وهزموهم أوقع اللّه الرعب في قلوبهم فتركوهم وفروا منهم من غير سبب. (والثاني): أنهم لما ذهبوا إلى مكة، فلما كانوا في بعض الطريق ندموا فقالوا بئس ما صنعتم إنكم قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تركتموهم ارجعوا فاستأصلوهم قبل أن يجدوا قوة وشوكة، فقذف اللّه في قلوبهم الرعب فذهبوا إلى مكة. 18- وكقوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} أي من التحريف والزيادة والنقصان مما تواتر عند علماء الأعيان من قراء الزمان، وقد وقع كما أخبر فما قدر أحد من الملاحدة والمعطلة والقرامطة أن يحرف شيئاً منه، لا حرفاً من حروف مبانيه ولا من حروف معانيه ولا إعراباً من إعراباته إلى هذه المدة التي نحن فيها، أعني ألفاً ومائتين وثمانين من الهجرة بخلاف التوراة والإنجيل وغيرهما كما عرفت في الباب الأول والثاني، والحمد للّه على إتمام هذه النعمة.
19- وكقوله تعالى: {لا يأتيه الباطل} أي التحريف بالزيادة والنقصان {من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد}، وحال هذا القول كالقول السابق. 20- وكقوله تعالى: {إن الذي فرض عليك القرآن} أي أحكامه وفرائضه {لرادك إلى معاد}. وروي أنه عليه السلام لما خرج من الغار وسار في غير الطريق مخافة الطلب فلما أمن رجع إلى الطريق، ونزل بالجحفة بين مكة والمدينة، وعرف الطريق إلى مكة واشتاق إليها، وذكر مولده ومولد أبيه، فنزل جبريل عليه السلام وقال: تشتاق إلى بلدك ومولدك؟ فقال عليه السلام: نعم، فقال جبريل عليه السلام: فإن اللّه تعالى يقول: {إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد} يعني إلى مكة ظاهراً عليهم. 21- وكقوله تعالى: {قل إن كانت لكم} أيها اليهود {الدار الآخرة عند اللّه خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبداً} أي ما عاشوا {بما قدمت أيديهم واللّه عليم بالظالمين}. والمراد بالتمني التمني بالقول، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدمه في الرأي والحزم وحسن النظر في العاقبة كما هو المسلم به عند المخالف والموافق والوصول إلى المنزل الذي وصل إليه في الدارين، والوصول إلى الرياسة العظيمة، لا يجوز له - وهو غير واثق من جهة الرب بالوحي - أن يتحدى أعدى الأعداء بأمر لا يأمن عاقبة الحال فيه، ولا يأمن من خصمه أن يقهره بالدليل والحجة، لأن العاقل الذي لم يجرب الأمور لا يكاد يرضى بذلك، فكيف الحال في أعقل العقلاء. فثبت أنه ما أقدم على هذا التحدي إلا بعد الوحي واعتماده التام. وكذا لا شك أنهم كانوا من أشد أعدائه، وكانوا أحرص الناس في تكذيبه، وكانوا متفكرين في الأمور التي بها ينمحي الإسلام أو تحصل الذلة لأهله، وكان المطلوب منهم أمراً سهلاً لا صعباً، فلو لم يكن النبي صلى اللّه عليه وسلم صادقاً في دعواه عندهم لبادروا إلى القول به لتكذيبه، بل أعلنوا هذا التمني بالقول مراراً وشهروا أنه كاذب يفتري على اللّه أنه قال كذا، ويدعي من جانب نفسه ادعاء ويقول تارةً: والذي نفسي بيده لا يقولها رجل منهم إلا غص بريقه، يعني مات مكانه، ويقول تارةً: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ونحن تمنينا مراراً وما متنا مكاننا فظهرت بصرفهم عن تمنيهم مع كونهم على تكذيبه أحرص الناس معجزته وبانت حجته، وفي هذه الآية إخباران عن الغيب: (الأول) أن قوله {لن يتمنوه} يدل دلالة بينة على أن ذلك لا يقع في المستقبل من أحد منهم فيفيد عموم الأشخاص. (والثاني) أن قوله أبداً يدل على أنه لا يوجد في شيء من الأزمنة الآتية في المستقبل يفيد عموم الأوقات فبالنظر إلى العمومين هما غيبان 22- وكقوله تعالى: {وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اللّه إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين} فأخبر بأنهم لا يفعلون ألبتة، ووقع كما أخبر، وهذه الآية دالة على الإعجاز من وجوه أربعة: (أولها) أنا نعلم بالتواتر أن العرب كانوا في غاية العداوة لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وفي غاية الحرص على إبطال أمره، لأن مفارقة الأوطان والعشيرة وبذل النفوس والمهج من أقوى الأدلة على ذلك، فإذا انضاف إليه مثل هذا التقريع وهو قوله: {فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا} صار حرصهم أشد، فلو كانوا قادرين على الإتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه لأتوا به، فحيث ما أتوا به ظهر الإعجاز. (وثانيها) أن النبي صلى اللّه عليه وسلم وإن كان متهماً عندهم في أمر النبوة، لكنه كان معلوم الحال في وفور العقل والفضل والمعرفة بالعواقب، فلو كان كاذباً لما تحداهم بالغاً في التحدي إلى النهاية، بل كان عليه أن يخاف مما يتوقعه من فضيحة يعود وبالها على جميع أموره، فلو لم يعلم بالوحي عجزهم عن المعارضة لما جاز أن يحملهم عليها بهذا التقريع.
(وثالثها) أنه لو لم يكن قاطعاً في أمره لما قطع في أنهم لا يأتون بمثله لأن المزور لا يجزم بالكلام، فجزمه يدل على كونه جازماً في أمره.
(ورابعها) أنه وجد مخبر هذا الخبر على ذلك الوجه، لأنه من عهده عليه السلام إلى عصرنا هذا لم يحل وقت من الأوقات من يعادي الدين والإسلام، وتشددوا عليه في الوقيعة فيه، ثم إنه مع هذا الحرص الشديد لم توجد المعارضة قط. فهذه الوجوه الأربعة في الدلالة على الإعجاز مما تشتمل عليه هذه الآية، فهذه الأخبار وأمثالها تدل على كون القرآن كلام اللّه، لأن عادة اللّه جارية على أن مدعي النبوة لو أخبر عن شيء ونسب إلى اللّه كذباً لا يخرج خبره صحيحاً. في الباب الثامن عشر من كتاب الاستثناء هكذا: (فإن أحببت وقلت في قلبك كيف أستطيع أن أميز الكلام الذي لم يتكلم به الرب). 22- فهذه تكون لك آية أن ما قاله ذلك النبي باسم الرب ولم يحدث فهذا الرب لم يكن تكلم به، بل ذلك النبي صوره في تعظيم نفسه ولذلك لا تخشاه).
(الأمر الرابع) ما أخبر من أخبار القرون السالفة والأمم الهالكة، وقد علم أنه كان أمياً ما قرأ ولا كتب ولا اشتغل بمدارسة مع العلماء ولا مجالسة مع الفضلاء، بل تربى بين قوم كانوا يعبدون الأصنام ولا يعرفون الكتاب، وكانوا عارين عن العلوم العقلية أيضاً، ولم يغب عن قومه غيبة يمكن له التعلم فيها من غيرهم، والمواضع التي خالف القرآن فيها في بيان القصص والحالات المذكورة [في] كتب أهل الكتاب كقصة صلب المسيح عليه السلام وغيرها فهذه لمخالفة قصدية: إما لعدم كون بعض هذه الكتب أصلية كالتوراة والإنجيل المشهورين، وإما لعدم كونها إلهامية، ويدل على ما ذكرت قوله تعالى: {إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون}.
(الأمر الخامس) ما فيه من كشف أسرار المنافقين حيث كانوا يتواطئون في السر على أنواع كثيرة من المكر والكيد، وكان اللّه يطلع رسوله على تلك الأحوال حالاً فحالاً، ويخبره عنها على سبيل التفصيل، فما كانوا يجدون في كل ذلك إلا الصدق، وكذا ما فيه من كشف حال اليهود وضمائرهم.
(الأمر السادس) جمعه لمعارف جزئية وعلوم كلية لم تعهد العرب عامة ولا محمد صلى اللّه عليه وسلم خاصة من علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجج العقلية والسير والمواعظ والحكم، وأخبار الدار الآخرة ومحاسن الآداب والشيم. وتحقيق الكلام في هذا الباب أن العلوم إما دينية أو غيرها ولا شك أن الأولى أعظمها شأناً وأرفعها مكاناً، فهي إما علم العقائد والأديان، وإما علم الأعمال. أما علم العقائد والأديان فهو عبارة عن معرفة اللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أما معرفة اللّه تعالى فهي عبارة عن معرفة ذاته ومعرفة صفات جلاله ومعرفة صفات إكرامه وأفعاله ومعرفة أحكامه ومعرفة أسمائه، والقرآن مشتمل على دلائل هذه المسائل وتفاريعها وتفاصيلها على وجه لا يساويه شيء من الكتب، بل لا يقرب منه، وأما علم الأعمال فهو إما أن يكون عبارة عن علم التكاليف المتعلقة بالظواهر، وهو علم الفقه. ومعلوم أن جميع الفقهاء إنما استنبطوا مباحثهم من القرآن، وإما أن يكون علم التصوف المتعلق بتصفية الباطن ورياضة القلوب، وقد حصل في القرآن من مباحث هذا العلم ما لا يوجد في غيره، كقوله: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} وقوله: {إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي} وقوله: {ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم} فقوله: {ادفع بالتي هي أحسن} يعني ارفع سفاهتهم وجهالتهم بالخصلة التي هي أحسن وهي الصبر ومقابلة السيئة بالحسنة. وقوله {فإذا الذي} إلخ يعني إذا قابلت إساءتهم بالإحسان وأفعالهم القبيحة بالأفعال الحسنة تركوا أفعالهم القبيحة وانقلبوا من العداوة إلى المحبة، ومن البغضة إلى المودة ونحو هذه الأقوال كثيرة فيه. فثبت أنه جامع لجميع العلوم النقلية أصولها وفروعها، ويوجد فيه التنبيه على أنواع الدلالات العقلية والرد على أرباب الضلال ببراهين قاهرة وأدلة باهرة سهلة المباني مختصرة المعاني، كقوله تعالى: {أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم} وكقوله تعالى: {يحيها الذي أنشأها أول مرة} وكقوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا} ولنعم ما قيل: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصرت عنه أفهام الرجال.
(الأمر السابع) كونه بريئاً عن الاختلاف والتفاوت مع أنه كتاب كبير مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم، فلو كان ذلك من عند غير اللّه لوقعت فيه أنواع من الكلمات المتناقضة، لأن الكتاب الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك. ولما لم يوجد فيه ذلك علمنا أنه ليس من عند غير اللّه كما قال اللّه تعالى: {أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً} وإلى هذه الأمور السبعة المذكورة أشار اللّه تعالى بقوله: {أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض} لأن مثل هذه البلاغة والأسلوب العجيب والإخبار عن الغيوب والاشتمال على أنواع العلوم والبراءة من الاختلاف والتفاوت، مع كون الكتاب كبيراً مشتملاً على أنواع العلوم لا يأتي إلا من العالم الذي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة مما في السماوات والأرض.
(الأمر الثامن) كونه معجزة باقية متلوّة في كل مكان مع تكفل اللّه بحفظه، بخلاف معجزات الأنبياء فإنها انقضت بانقضاء أوقاتها، وهذه المعجزة باقية على ما كانت عليه من وقت النزول إلى زماننا هذا، وقد مضت مدة ألف ومائتين وثمانين وحجتها قاهرة، ومعارضته ممتنعة وفي الأزمان كلها القرى والأمصار مملوءة بأهل اللسان وأئمة البلاغة، والملحد فيهم كثير والمخالف العنيد حاضر ومهيأ، وتبقى إن شاء اللّه هكذا ما بقيت الدنيا وأهلها في خير وعافية. ولما كان المعجز منه بمقدار أقصر سورة فكل جزء منه بهذا المقدار معجزة، فعلى هذا يكون القرآن مشتملاً على أكثر من ألفي معجزة.
(الأمر التاسع) أن قارئه لا يسأمه وسامعه لا يمجه، بل تكراره يوجب زيادة محبته كما قيل:
وخير جليس لا يمل حديثه * وترداده يزداد فيه تجملا
وغيره من الكلام، ولو كان بليغاً في الغاية يمل مع الترديد في السمع ويكره في الطبع، ولكن هذا الأمر بالنسبة إلى من له قلب سليم لا إلى من له طبع سقيم.
(الأمر العاشر) كونه جامعاً بين الدليل ومدلوله فالتالي له إذا كان ممن يدرك معانيه يفهم مواضع الحجة والتكليف معاً في كلام واحد باعتبار منطوقه ومفهومه، لأنه ببلاغة الكلام يستدل على الإعجاز، وبالمعاني يقف على أمر اللّه ونهيه ووعده ووعيده.
(الأمر الحادي عشر) حفظه لمتعلميه بالسهولة، كما قال اللّه تعالى: {ولقد يسرنا القرآن للذكر} فحفظه ميسر على الأولاد الصغار في أقرب مدة ويوجد في هذه الأمة في هذا الزمان أيضاً مع ضعف الإسلام في أكثر الأقطار أزيد من مائة ألف من حفاظ القرآن بحيث يمكن أن يكتب القرآن من حفظ كل منهم من الأول إلى الآخر، بحيث لا يقع الغلط في الإعراب فضلاً عن الألفاظ ولا يخرج في جميع ديار أوربا عدد حفاظ الإنجيل بحيث يساوي الحفاظ في قرية من قرى مصر مع فراغ بال المسيحيين وتوجههم إلى العلوم والصنائع منذ ثلثمائة سنة، وهذا هو الفضل البديهي لأمة محمد صلى اللّه عليه وسلم ولكتابهم.
(الأمر الثاني عشر) الخشية التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماع القرآن، والهيبة التي تعتري تاليه، وهذه الخشية قد تعتري من لا يفهم معانيه ولا يعلم تفسيره، فمنهم من أسلم لها لأول وهلة ومنهم من استمر على كفره، ومنهم من كفر حينئذ ثم رجع بعده إلى ربه.
روي أن نصرانياً مر بقارئ فوقف يبكي فسئل عن سبب البكاء فقال الخشية التي حصلت له من أثر كلام الرب، وأن جعفر الطيار رضي اللّه عنه لما قرأ القرآن على النجاشي وأصحابه ما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر رضي اللّه عنه من القراءة، وأن النجاشي أرسل سبعين عالماً من العلماء المسيحية إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقرأ عليهم سورة (يس) فبكوا وآمنوا فنزل في حق الفريقين أو أحدهما قوله تعالى: {وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين} وقد عرفت حال جبير بن مطعم رضي اللّه عنه، وعتبة، وابن المقنع، ويحيى بن حكم الغزالي. وقال نور اللّه الشوستري في تفسيره: إن العلامة علي القوشجي لما راح من وراء النهر إلى الروم جاء إليه حبر من أحبار اليهود لتحقيق الإسلام وناظره إلى شهر وما سلم دليلاً من أدلة العلامة إلى هذا الحين فجاء يوماً وقت الصبح وكان العلامة مشتغلاً بتلاوة القرآن على سطح الدار، وكان كريه الصوت في الغاية، فلما دخل الباب وسمع القرآن أثر القرآن في قلبه تأثيراً بليغاً، فلما وصل إلى العلامة قال: إني أدخل في الإسلام فأدخله العلامة في الإسلام ثم سئل عن السبب فقال: ما سمعت مدة عمري كريه الصوت مثلك، فلما وصلت إلى الباب سمعت منك القرآن وقد حصل تأثيره البليغ فيَّ فعلمت أنه وحي. فثبت من الأمور المذكورة أن القرآن معجز وكلام اللّه، كيف لا وحسن الكلام يكون لأجل ثلاثة أشياء: أن تكون ألفاظه فصيحة وأن يكون نظمه مرغوباً، وأن يكون مضمونه حسناً. وهذه الأمور الثلاثة متحققة في القرآن بلا ريب ونختم هذا الفصل ببيان ثلاث فوائد:
(الفائدة الأولى) سبب كون معجزة نبينا من جنس البلاغة أيضاً أن بعض المعجزات تظهر في كل زمان من جنس ما يغلب على أهله أيضاً، لأنهم يبلغون فيه الدرجة العليا فيقفون فيه على الحد الذي يمكن للبشر الوصول إليه، فإذا شاهدوا ما هو خارج عن الحد المذكور علموا أنه من عند اللّه، وذلك كالسحر في زمن موسى عليه السلام فإنه كان غالباً على أهله وكاملين فيه، ولما علم السحرة الكملة أن حد السحر تخييل لما لا ثبوت له حقيقة ثم رأوا عصاه انقلبت ثعباناً يتلقف سحرهم الذي كانوا يقلبونه من الحق الثابت إلى المتخيل الباطل من غير أن يزداد حجمها، علموا أنه خارج عن السحر ومعجزة من عند اللّه فآمنوا به. وأما فرعون فلما كان قاصراً في هذه الصناعة ظن أنه سحر أيضاً، وإن كان أعظم من سحر سحرته. وكذا الطب لما كان غالباً على أهل زمن عيسى عليه السلام، وكانوا كاملين فيه، فلما رأوا إحياء الميت وإبراء الأكمه علموا بعلمهم الكامل أنهما ليسا من حد الصناعة الطبية، بل هو من عند اللّه. والبلاغة قد بلغت في عهد الرسول عليه السلام إلى الدرجة العليا وكان بها فخارهم حتى علقوا القصائد السبع بباب الكعبة تحدياً لمعارضتها كما تشهد به كتب السير، فلما أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم بما عجز عن مثله جميع البلغاء عُلم أن ذلك من عند اللّه قطعاً.
(الفائدة الثانية) نزول القرآن منجماً ومفرقاً ولم ينزل دفعة واحدة بوجوه: (أحدها) أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يكن من أهل القراءة، فلو نزل عليه ذلك جملة واحدة كان لا يضبطه، ولجاز عليه السهو. (وثانياً) أنه لو أنزل عليه الكتاب دفعة فربما اعتمد على الكتاب وتساهل في الحفظ، فلما أنزل اللّه منجماً حفظه وبقي سنة الحفظ في أمته. (وثالثها) في صورة نزول الكتاب دفعة لو كان نزول جميع الأحكام دفعة واحدة على الخلق لكان يثقل عليهم ذلك، ولما نزل مفرقاً لا جرم نزلت التكاليف قليلاً قليلاً، فكان تحملها أسهل، كما روي عن بعض الصحابة أنه قال: لقد أحسن اللّه إلينا كل الإحسان، كنا مشركين فلو جاءنا رسول اللّه بهذا الدين جملة وبالقرآن دفعة لثقلت هذه التكاليف علينا فما كنا ندخل في الإسلام ولكنه دعانا إلى كلمة واحدة فلما قبلناها وذقنا حلاوة الإيمان قبلنا ما وراءها كلمة بعد كلمة إلى أن تم الدين وكملت الشريعة. (ورابعها) أنه إذا شاهد جبريل حالاً بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته فكان أقوى على أداء ما حمل، وعلى الصبر على عوارض النبوة، وعلى احتمال أذية القوم. (وخامسها) أنه لما تم شرط الإعجاز فيه مع كونه منجماً ثبت كونه معجز، فإنهم لو قدروا لوجب أن يأتوا بمثله منجماً مفرقاً. (وسادسها) كان القرآن ينزل بحسب أسئلتهم والوقائع الواقعة لهم، فكانوا يزدادون بصيرة، لأن الإخبار عن العيوب كان ينضم بسبب ذلك إلى الفصاحة. (وسابعها) أن القرآن لما نزل منجماً مفرقاً وتحداهم النبي صلى اللّه عليه وسلم من أول الأمر فكأنه تحداهم بكل واحد من نجوم القرآن، فلما عجزوا عنه كان عجزهم عن معارضة الكل أولى فثبت بهذا الطريق أن القوم عاجزون عن المعارضة لا محالة. (وثامنها) أن السفارة بين اللّه وبين أنبيائه وتبليغ كلامه إليهم منصب عظيم، فلو نزل القرآن دفعة واحدة كان زوال هذا المنصب عن جبريل عليه السلام محتملاً. فلما نزل مفرقاً منجماً بقي ذلك المنصب العظيم عليه.
(الفائدة الثالثة) سبب تكرار بيان التوحيد وحال القيامة وقصص الأنبياء في مواضع أن العرب كانوا مشركين وثنيين ينكرون هذه الأشياء، وغير العرب بعضهم مثل أهل الهند والصين والمجوس كانوا مثل العرب في الإنكار، وبعضهم كأهل التثليث كانوا في الإفراط والتفريط في اعتقاد هذه الأشياء، فلأجل التقرير والتأكيد كرر بيان هذه الأشياء. ولتكرار القصص أسباب أخر أيضاً، منها: أن إعجاز القرآن لما كان باعتبار البلاغة أيضاً وكان التحدي بهذا الاعتبار فكررت القصص بعبارات مختلفة إيجازاً وإطناباً مع حفظ الدرجة العليا للبلاغة في كل مرتبة ليعلم أن القرآن ليس كلام البشر، لأن هذا الأمر عند البلغاء خارج عن القدرة البشرية. ومنها أنه كان لهم أن يقولوا إن الألفاظ الفصيحة التي كانت مناسبة لهذه القصص استعملتها وما بقيت الألفاظ الأخرى مناسبة لها، وأن يقولوا إن طريق كل بليغ يخالف طريق الآخر، فبعضهم يقدر على الطريق المطنب، وبعضهم يقدر على الموجز فلا يلزم من عدم القدرة على نوع عدم القدرة مطلقاً. أو أن يقولوا إن دائرة البلاغة ضيقة في بيان القصص وما صدر عنك بيانها مرة محمول على البخت والاتفاق فلما كررت القصص إيجازاً وإطناباً لم يبق عذر من هذه الأعذار الثلاثة. ومنها أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يضيق صدره بإيذاء القوم وشرهم كما أخبر اللّه تعالى: {ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون} فيقص اللّه قصة من قصص الأنبياء مناسبة لحاله في ذلك الوقت لتثبيت قلبه، كما أخبر اللّه تعالى: {وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين}. ومنها أن المسلمين كان يحصل لهم الإيذاء من أيدي الكفار، أو أن قوماً كانوا يسلمون، أو أن الكفار كان المقصود تنبيههم فكان اللّه ينزل في كل موضع من هذه القصص ما يناسبه، لأن حال السلف تكون عبرة للخلف. ومنها أن القصة الواحدة قد تشتمل على أمور كثيرة فتذكر تارةً وتقصد بها بعض الأمور قصداً، وبعضها تبعاً وتعكس مرة أخرى . والحق أنها لا تملك من مقومات الدولة أي شيء فما زالت تعيش على إعانات بعض الدول الأجنبية في فزع ورعب دائم.. وعن قريب سيطردها العرب من أرضهم شر طردة ولن يلتئم لهم شمل، ولن يتنصر لهم جيش وسيهزم الجمع ويولون الدبر {وعد اللّه لا يخلف اللّه وعده}.




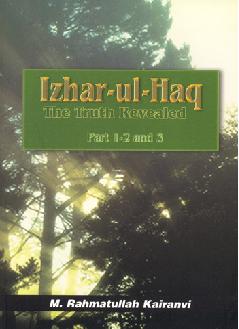










0 التعليقات:
إرسال تعليق